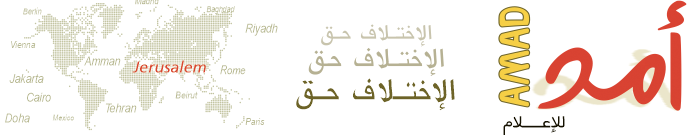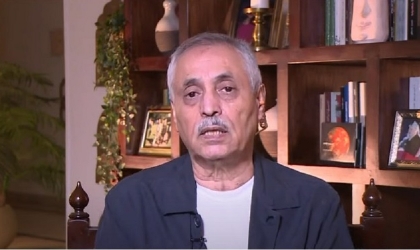التحوّل من هيمنة الشعر إلى مشروع الرواية: قراءة في تجربة خندقجي الإبداعية

فراس حج محمد
أمد/ ملاحظة: صدر عن "ناشرون فلسطينيون" النسخة الإلكترونية من كتاب "الأسوار والكلمات- عن أدب باسم خندقجي" للناقد الفلسطيني فراس حج محمد، علما أن الكتاب متاح للتحميل المجاني على منصات الكتب الإلكترونية: مكتبة كتوباتي، ومكتبة نور الإلكترونية، وموقع الكاتب الشخصي.
شكل كتاب "الأسوار والكلمات- عن أدب باسم خندقجي" للكاتب فراس حج محمد، الصادر عام 2025، إطاراً نقدياً ومعرفياً شاملاً لأدب الكاتب الأسير الذي أمضى أكثر من عشرين عاماً خلف القضبان، ويُمثل هذا العمل محاولة للانتقال بدراسة أدب خندقجي من سياق التضامن السياسي والعاطفي إلى سياق التحليل الفني والفكري العميق، وقد خلص الكتاب إلى مجموعة من المقولات الجوهرية التي تحدد منزلة باسم خندقجي الأسلوبية والفكرية ضمن مسيرة الأدب الفلسطيني وأدب الأسرى، مؤكداً امتلاكه لـ"بصمة خاصة" في هذا المجال.
أولاً: الكتابة فعل تحرري ووجودي متجاوز للسجن
ترتكز الرؤية النقدية للكتاب على مقولة مفادها أن أدب خندقجي ليس توثيقاً لتجربة الاعتقال وحسب بما فيها من معاناة وقهر وإذلال، بل استراتيجية وجودية متكاملة لمقاومة القيد، ويرى الناقد حج محمد أن خندقجي كان "نموذجاً للكاتب الذي لم يستسلم لقدره"، متخذاً من الكتابة "متنفساً له".
لقد أشار التحليل الموضوعي لأعمال خندقجي إلى أن هذا الكاتب الأسير قد "ألغى فكرة السجن تماماً" في ما كتبه من شعر وروايات، حيث نادراً ما يُشير إلى كونه سجيناً، باستثناء بعض الملحوظات العابرة حول مكان كتابة رواية معينة، مثل رواية "محنة المهبولين". هذا التجاهل المنهجي للقيود المادية يرفع فعل الإبداع إلى مستوى التحرر الوجودي، إذ يصبح القلم أداة لاستعادة السيطرة الذاتية على المصير، إن الكتابة بذلك لا تشكل وسيلة تعبير فقط، بل أيضاً فعل مقاومة شرسة لـ"عوامل الموت والضياع والتهميش"، وكأنها عملية "تكسير لإرادة السجان".
ويُشدّد الكتاب على أن هذه القوة الإرادية لم تأتِ على حساب الجودة الفنية. على العكس من ذلك تماماً، فإن خندقجي وغيره من الكتاب الأسرى "لم يتكئوا على كونهم أسرى ليعوضوا التقنيات الفنية". بل نجحوا في تجاوز المباشرة و"ارتفاع صوت القضية" الذي عادة ما يقع فيه الكتاب المناضلون. إن هذا النجاح الفني هو ما أهله ليكون أدبه ذا "عبقرية" حقيقية، قادرة على هزيمة السجان وهزيمة الشعار الآني بـ"الشعر الخالص"، ويؤكد الناقد أن إبدا خندقجي يمثل "أدب الحرية"، وهو ما يفسر الاهتمام الأكاديمي المتزايد برواياته، كما يتضح من الأبحاث المحكمة التي تناولت رواية قناع بلون السماء، حيث يستعرض كتاب "الأسوار والكلمات" ثلاثة من تلك الأبحاث.
ثانياً: التحول من هيمنة الشعر إلى مشروع الرواية طويل النفَس
تتبع الكتاب مسيرة خندقجي الإبداعية، مسجلاً تحولاً حاسماً من الشعر إلى الرواية، وهو تحول لم يكن فنياً فحسب، بل أيديولوجياً وإبداعياً متجذراً في السياق الفلسطيني، إذ بدأت تجربة باسم في حدها المنشور الذي بدأ عام 2009 بديوان "من طقوس المرة الأولى" الذي وُصف بأنه شعر "خالص" نجا من "براثن المباشرة والخطابية والكليشيهات المألوفة"، وتميز الديوان- كما جاء في قراءة حج محمد النقدية- بأسلوبه الهادئ الرزين، متوسلاً الغموض وتوظيف ضمير المخاطب والتطلع إلى أفق الأمل القادم، ومع ذلك، فإن الديوان اللاحق، "أنفاس قصيدة ليلية" (2013)، وُصف بأنه "أقل مستوى من الناحية الفنية"، ما دفع الناقد إلى عدم الكتابة عنه.
يُشير الكتاب إلى رسالة خندقجي التي أكد فيها "انحيازاته الأدبية للرواية والابتعاد عن الشعر". وقد برر خندقجي هذا الابتعاد بأنه اكتشف أن "النص الطويل النفس أجدى في حالاتنا الفلسطينية والعربية"، معترفاً بأنه ليس شاعراً.
ويُفسر هذا التحول جزئياً بالهوية الشعرية الطاغية لمحمود درويش الذي وصفه خندقجي بقوله: "أنضجني وزاد من نسبة الحلم في دمي"، وأن درويش "يكفينا كشاعر لأكثر من مئة عام قادم"، هذه السيطرة الدرويشية، وفقاً للتحليل، دفعت خندقجي إلى استثمار لغته الشعرية في السرد، وقد أنتج هذا المزج نصوصاً تجريبية مثل "نرجس العزلة" التي صنفها صاحبها تحت تجنيس "منثور روائي"، كآلية للتحرر من شروط الرواية الكلاسيكية، ومع أن هذا المنثور الروائي كان ناجحاً في تحقيق مساءلة الذات، إلا أن اللغة الشعرية الطافحة أحياناً في أعمال أخرى مثل رواية "أنفاس امرأة مخذولة" تسببت في "فيض إنشائي" و"لغة بلا هدف"، مما شكل فخاً سردياً أضر بجماليته الفنية، انطلاقا من أن للرواية لغة تختلف في طبيعتها عن اللغة الشعرية، وهذا ما يورده الناقد نفسه في دراسات وكتب أخرى.
ثالثاً: الميزان النقدي: خطورة طفو الخطاب الأيديولوجي المباشر
وضع الكتاب معياراً نقدياً جوهرياً لتقييم أدب خندقجي، وهو التمييز بين حضور الفكرة كـ"روح شفيف" وبين طغيانها كـ"دعاية فكرية"، ويؤكد الناقد أن أي عمل أدبي لا يمكن أن يخلو من أيديولوجيا، ولكن النجاح يكمن في جعل الأفكار "خلفية للعمل كروح شفيف تسري بين مفاصله، بحيث يكون الظهور الأول للفن وليس للدعاية الفكرية"، وبتطبيق هذا المعيار على رواية "قناع بلون السماء" التي فازت بجائزة البوكر 2024، توصل الناقد إلى أن الرواية لم تكن أفضل روايات باسم من الناحية الفنية. ويعود هذا التقييم إلى أن "النزعة الفكرية تعلو في الرواية، لتغدو خطاباً أيديولوجياً أكثر منها خطاباً روائياً"، هذا الموقف النقدي الحاد له ما يدعمه لدى نقاد آخرين تحدثوا عن الرواية، وتناولوها بالدراسة والتحليل، وله من يخالفه كذلك؛ فثمة نقّاد أشادوا بالرواية من ناحية فنية، ورفعها إلى درجة التجريب الروائي.
وفي مقابل هذا التراجع الفني النسبي في العمل الأكثر شهرة، يرى الناقد أن روايات خندقجي السابقة؛ "مسك الكفاية" و"نرجس العزلة" و"أنفاس امرأة مخذولة" و"محنة المهبولين"، "تفوقها فنياً"، وهذا التقييم يُشير إلى تناقض عميق، حيث أن الاعتراف العالمي المُبهر (البوكر) أتى للعمل الذي تراجعت فيه الصنعة الفنية لصالح الضخ المباشر للرسالة الأيديولوجية والسياسية، لقد كانت مباركة الناقد للفوز مبنية أولاً على "اعتبارات سياسية تضامنية"، لا على أساس تفوق العمل فنياً.
رابعاً: الأبعاد الفكرية والرمزية في الأعمال الروائية الكبرى
قدم الكتاب تحليلات معمقة لمشروع خندقجي الروائي، مستخلصاً منه مقولات فلسفية ورمزية كبرى:
1. رواية مسك الكفاية: تثوير التاريخ والفكر الاشتراكي
أشار التحليل إلى أن خندقجي "انحاز للتاريخ" في أعماله، وكان هدف هذا الانحياز "أن يستمد من التاريخ عبرة لا أن يهرب إلى دهاليزه"، وفي "مسك الكفاية- سيرة سيدة الظلال الحرة" استخدم التاريخ العباسي لإعادة تفعيل قضايا الحرية والعدالة والمساواة، وتمحورت الرواية حول رموز ثلاثة ذات دلالة فكرية:
* المرأة (الخيـزران): تجسيد لرحلة الكرامة الإنسانية من الحرية الفطرية إلى الرق ثم البحث عن "الحرية المكتسبة" عبـر الوعي، وهي تمثل إرادة لا تقهر، وقدرة المرأة على امتلاك السلطة والحكم.
* الصحراء: رمز لـ"بيئة عربية خالية من الأحقاد والضغائن" ومحملة بـ"الأفكار الأيديولوجية الاشتراكية التي تمقت الطبقية"، وقد كانت الصحراء هي البديل الأخلاقي والاجتماعي المضاد لبيئة الحاضرة العباسية التي سادت فيها شهوتا الحكم والنساء.
* العباءة: رمز للحماية والقداسة والوفاء الروحي لعشق مُتعذّر.
ويُفهم من هذا التباين الروائي أن العمل يعكس صراعاً أيديولوجياً يرى فيه الكاتب المنتمي لليسار أن الفكرة الاشتراكية، الممثلة في الصحراء، لم تمت وما زالت قادرة على تقديم بديل للواقع المعيش القائم على الفكرة الرأسمالية.
2. رواية نرجس العزلة: محاكمة الذات ونقد السلطة
اعتمدت الرواية تقنية التجريب عبـر "التخييل الذاتي"، حيث وظف خندقجي تناوب ضمائر السرد الثلاث (أنت، هو، أنا) في فصولها الخمسة لإنجاز "محاكمة الذات ومساءلتها". وقد تجاوز العمل البناء الكلاسيكي للرواية، واختار له مصطلح "منثور روائي".
تضمنت الرواية مراجعة لخمسة وعشرين عاماً من النضال والحب، وانعكس فيها موقف خندقجي اليساري الثابت على مبادئه، وتجلت مقولته النقدية الأيديولوجية الأبرز في وصف السلطة الفلسطينية التي أفرزتها أوسلو بـ"شبه جملة وطنية" و"وهم لا أكثـر"، معبـراً عن التيه والخذلان المدمن الذي يعاني منه الفلسطينيون، ويُشير التحليل إلى أن القصيدة (التي هجرها) مثلت في الرواية "الوطن المؤقت"، حيث وجد الشاعر ملاذه الروحي والمنقذ من الفشل السياسي في نقاء الحلم الشعري.
3. رواية محنة المهبولين: فلسفة الهبل كشرط للصدق الوجودي
تُعد هذه الرواية بياناً فلسفياً متقدماً، وتقوم المقولة الفلسفية الأساسية التي يستخلصها التحليل على أن "الهبل" (الجنون) المطروح في الرواية ليس مرضياً، بل "جنون وجودي يمثل الملاذ الأخير للذات المتمردة التي ترفض الخضوع لمنطق العقلانية الزائفة" والقانون الاجتماعي الظالم، فالصدق لا يتحقق إلا عبـر هذا الجنون.
استخدمت الرواية تقنية التناص الروائي مع أيقونات الأدب الغربي (فرانكنشتاين، وجان فالجان، وإيما بوفاري)، وذلك بهدف مزدوج؛ إظهار أن البؤس والظلم ليسا حكراً على الشرق، وإدانة "الغرب المتوهج" من خلال نزع القدسية عنه.
أبرز ما في الرواية هو الميتاقص الختامي الذي يربط بين الفضاء الروائي وواقع الكاتب. إذ يلاحظ الناقد تطابق "صندوق" أنيس البياراتي- الذي يهرب فيه كـ"تابوت" أو "رحم" للولادة الجديدة- مع "صندوق سجن هدريم"؛ حيث كُتبت الرواية، وهذا يثبت أن التحرر الفلسفي والصدق الأدبي يُنجزان من قلب العزلة القسرية، ويرى الناقد أن تحرر خندقجي عام 2025 بفعل صفقات الطوفان الموصوف بأنه "مغامرة غير محسوبة" عند بعض المحللين السياسيين والعسكريين، يُعيد تأكيد أن "جنون" الثورة هو الوحيد القادر على إنهاء القيد المؤبد، في دعم غيـر مباشر للفعل الثوري المتطرف ضد المنطق العقلاني المستسلم.
خامساً: النقد السياسي الأيديولوجي: شيطنة رام الله وخطاب البوكر المتواطئ
لم يقتصر نقد الكتاب على الجوانب الفنية، بل امتد ليطال المواقف الأيديولوجية لخندقجي وللجهات الداعمة للأدب، من ذلك:
1. نقد رام الله كرمز للفشل الوطني
يُصنف خندقجي ضمن الكتاب "الذين يهجون رام الله لاعتبارات سياسية"، حيث يراها مدينة ديستوبيا وإحدى إفرازات اتفاقية أوسلو، ويشير الناقد إلى أن خندقجي، كونه عضواً في اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، يأتي نقده لرام الله والسلطة ليؤكد الانشقاق الأيديولوجي في صفوف اليسار الفلسطيني الذي لم يرتضِ بـ"الخيار الوهمي"، هذا الموقف يُعزز المقولة الضمنية بأن العزلة القسرية في السجن هي مصدر الرؤية السياسية الأكثر صدقاً ووضوحاً.
2. خطاب البوكر: التغييب المتعمّد لقضية الأسير
وجه الكتاب نقداً لاذعاً لخطاب الإعلان عن فوز خندقجي بجائزة البوكر 2024، وقد وُصف الخطاب بأنه "هزيل" لأنه فشل في الإشارة بوضوح إلى باسم خندقجي كأسير فلسطيني، وعن سبب سجنه، بل غيَّب القضية الفلسطينية عموماً، ويرى الناقد أن هذا التغييب كان متعمداً، وأن الخطاب كان "خطاب المتواطئ، أو خطاب الجبان على أحسن تقدير"، لأنه سعى لإرضاء الاحتلال وإرضاء أنظمة التطبيع العربية، وكانت المقولة النقدية الحادة هي أن الجائزة في سياقها هذا قد تكون "رشوة على الوطن"، وقد طالب الناقد بأن يكون الفوز فرصة لـ"التشنيع على جرائم الاحتلال"، واقتـرح منح الجائزة مناصفة لخندقجي وأسامة العيسة- وقد وصل كلاهما إلى قائمة جائزة البوكر القصيرة عام 2024- لربط الأدب بالقضية الفلسطينية العادلة.
تشير هذه الملاحظات إلى أن الأدب الفلسطيني، رغم انتصاره الرمزي، قد يقع ضحية للتطبيع الثقافي الذي يسعى لاستهلاك المنتج الفنـي مع إفراغه من سياقه السياسي المقاوم، وفي هذا خطورة بالغة على مجمل الخطاب الثقافي الفلسطيني الناشئ في ظل ظروف معقدة وحساسة سياسياً، حيث تواجه القضية الفلسطينية أخطر مرحلة من مراحلها، والشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الممارسات العنفية من الاحتلال المنفلتة من أي قانون أو أخلاقيات، سواء في ذلك في غزة أو في الضفة الغربية والقدس.
سادساً: الخاتمة والدعوة لـ"أدب الحرية"
يختتم الكتاب ببيان واضح يدعو فيه إلى دعم مشروع أدب الأسرى، مؤكداً أن العمل النقدي هذا يمثل "لبنة معرفية ونقدية تضاف إلى مجمل الأعمال النقدية التي تناولت أدب الأسرى؛ أدب الحرية".
إن المقولة الختامية الجامعة للكتاب هي الدعوة الصريحة لـ"أعمال مشابهة تتناول كتّاباً أسرى آخرين ممن تركوا إرثا أدبياً في سجون الاحتلال"، لأن من قدم "زهرة شبابه في السجن دفاعاً عن القيمة العليا للحياة يستحق أن نكتب فيه وله الكتب والدراسات".
ويطالب الناقد المؤسسات الرسمية والثقافية الفلسطينية كوزارة الثقافة واتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين بوضع استراتيجية واضحة ومدروسة لدعم هذا الأدب، ويشير إلى أن الكتّاب الأسرى "يهربون إبداعاتهم كما يهربون نطفهم"، مما يعطي فعل الكتابة معنى مرادفاً للمقاومة الوجودية واستمرار الحياة، ويستنتج التحليل أن المستويات الفنية الراقية التي وصل إليها أدب خندقجي تُملي على هذه المؤسسات مسؤولية تجاوز مفهوم التوثيق الوطني إلى التعامل مع هذا الأدب كفنٍّ رفيع يستوجب القراءات المقارنة والترجمة على نطاق عالمي واسع لمواجهة محاولات التغييب الدولي.